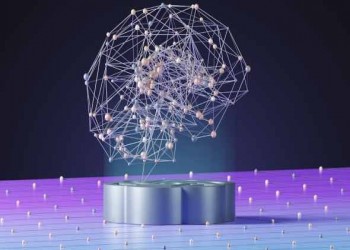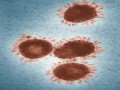الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب مغربية
- بطولات
- أخبار الاندية المغربية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
قمامة من؟

أمينة خيري
بقلم : أمينة خيري
تلقيت رسائل عديدة من قراء أعزاء للتعليق على مقال «سؤال القمامة»، والذى تطرقت فيه إلى القمامة التى تؤذى قلوبنا وعقولنا وأنوفنا وصحتنا فى شوارعنا وأماكنا العامة، وللعلم أن هذا الإيذاء يلحق بالجميع بمن يعتقد أنه تواؤم وتعايش سلميا وعاطفيا مع تلال القمامة، مشهدا وتأثيرا. إنه أحد الآثار الجانبية بالغة السلبية لمنظومة الاعتياد. يعتاد البعض القبح أو الضرر أو الإيذاء أو جميعها، فيتعايش معها ويعتقد أنها لا تمثل معضلة له، والحقيقة عكس ذلك.
كتبت فى المقال السابق عن «حاجة غلط» فى مشهد القمامة، فكيف لبلد عظيم وقديم، ويفاخر بحضارته وإنجازاته على مر القرون، ورغم ذلك يلقى أبناؤه وبناته قمامتهم فى عرض الشارع وعلى الرصيف، بما فى ذلك الأماكن التى يجلسون فيها لتناول الطعام أو للفسحة أو انتظار الأتوبيس؟! وربطت بين الشىء الغامض غير المفهوم الذى يجعل كثيرين يتماهون مع منظومة القمامة، فلا تضايقهم أو تقلق مضاجعهم، أو تزكم أنوفهم، أو تتعارض مع هذا القدر البالغ من مظاهر التدين.
وكما هو متوقع، أرسل البعض، مستنكرا لهذا الربط، أسئلة عدة، دارت فى فلك واحد: «ما علاقة التدين بالقمامة؟» وأكرر من جهتى أن العلاقة وطيدة. فكيف لشخص بلغ أعلى درجات الرقى الأخلاقى والسمو السلوكى، ورغم ذلك يصر على إلقاء قمامة محله على بابه، أو يدخل المسجد ليصلى ولا يلفت انتباهه تل القمامة القابع على الباب، وذلك على سبيل المثال لا الحصر.
وتدور أسئلة أخرى حول متلازمة مسؤولية الحكومة لا المواطن، وهذه إشكالية. فمن جهة، تقع على عاتق الحكومات عموما مسؤولية وضع اللوائح والتخطيط والتمويل وإنفاذ القوانين المتعلقة بإدارة النفايات، ويشمل ذلك جمع النفايات وتخزينها والتخلص منها، كما تعد الحكومات، بالتعاون مع الإعلام والمجتمع المدنى، الجهات المسؤولة عن التثقيف العام حول تقليل النفايات وإعادة استخدامها وإعادة تدويرها، وبالطبع عدم إلقاء قمامة المحل على الرصيف، وكيس الفول والطعمية والحلوى وغيرها فى عرض الشارع، ومن جهة أخرى، يصعب على الحكومات تعيين ضابط أو عسكرى مهمته السير خلف كل مواطن للتأكد من أنه لم يلقِ قمامته أينما حل.
بقى بند ثالث من التعليقات التى لفتت انتباهى وهى علاقة تمت صناعتها بين الفقر والقمامة، وهى العلاقة التى أرفضها تماما. يقول البعض إن «البسطاء» هم الأكثر تخلصا من القمامة فى الأماكن العامة، وذلك لنقص الوعى وقلة الموارد المادية التى تمكن صاحب المحل البسيط من شراء سلة قمامة يضعها على باب المحل، مفضلا إلقاء مخلفاته على الرصيف بهدف التوفير، وغيرها من الأمثلة.
لكن ماذا عمن يقود سيارة ثمنها بضعة ملايين، ويفتح النافذة ليتخلص من عبوة مياه معدنية أو علبة سجائر مستوردة فى عرض الطريق؟ وماذا عن أطفال ومراهقين فى نوادٍ تضم «صفوة المجتمع» لا يتوانون عن إلقاء بقايا ما يأكلون على الأرض، بينما أحاديثهم تدور بإنجليزية متقنة تماما؟. وللحديث بقية.
GMT 17:39 2025 الثلاثاء ,11 تشرين الثاني / نوفمبر
«القاعدة» في اليمن... ليست راقدة!GMT 17:36 2025 الثلاثاء ,11 تشرين الثاني / نوفمبر
كيف اخترق ممداني السَّدين؟GMT 17:34 2025 الثلاثاء ,11 تشرين الثاني / نوفمبر
لحظة ساداتية لبنانية ضد الهلاكGMT 17:30 2025 الثلاثاء ,11 تشرين الثاني / نوفمبر
جريمة أستاذ الجامعةGMT 17:12 2025 الثلاثاء ,11 تشرين الثاني / نوفمبر
مصر تفرح بافتتاح المتحف الكبير (2)GMT 17:10 2025 الثلاثاء ,11 تشرين الثاني / نوفمبر
أخطأ ياسر ولكنه لم ينافق!!GMT 16:54 2025 الثلاثاء ,11 تشرين الثاني / نوفمبر
الفتنة الكبرى!GMT 16:53 2025 الثلاثاء ,11 تشرين الثاني / نوفمبر
المشروع الوطنىشركة صينية تنشئ مصنع إلكترونيات في المغرب
الرباط - المغرب اليوم
أعلنت شركة "Boway Alloy" الصينية عن خطتها لاستثمار 150 مليون دولار لبناء مصنع في المغرب بقدرة إنتاجية تصل إلى 30 ألف طن سنوياً من شرائط المواد الإلكترونية المصنوعة من السبائك الخاصة التي تستخدم في تصنيع مكونات المنتج�...المزيديسرا تتسلّم وسام الشرف الفرنسي تقديراً لمسيرتها الفنية الطويلة
القاهرة - المغرب اليوم
نشرت الفنانة يسرا من خلال حسابها الخاص في "إنستغرام" فيديو ظهرت فيه وهي تتسلّم وسام الشرف الفرنسي من السفير الفرنسي في القاهرة، تقديراً لمسيرتها الفنية الثرية وإسهاماتها الكبيرة في تعزيز الحوار الثقافي بين م�...المزيدباحثون يطوّرون أطلساً دماغياً مدعوماً بالذكاء الاصطناعي لتحليل صور الدماغ بدقة
لندن - المغرب اليوم
طوّر باحثون من كلية لندن الجامعية أطلسًا دماغيًا جديدًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي يُسمّى "NextBrain"، يتضمن خريطة شاملة لدماغ الإنسان البالغ، ويمكنه تحليل صور الرنين المغناطيسي للأشخاص الأحياء في غضون دقائق، وب�...المزيد19 ألف زائر يومياً للمتحف المصري الكبير منذ افتتاحه للجمهور مطلع نوفمبر
القاهرة - المغرب اليوم
أعلنت إدارة المتحف المصري الكبير عن وصول متوسط معدل الزيارات اليومية إلى 19 ألف زائر، منذ افتتاحه للجمهور في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، وأكدت في بيان نشرته، الاثنين، أن المتحف استقبل 12 ألف زائر من المصريين والأج...المزيد Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©