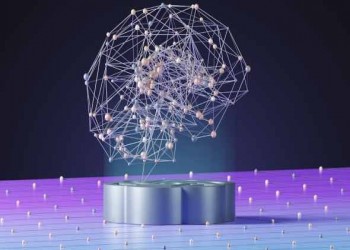الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب مغربية
- بطولات
- أخبار الاندية المغربية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
الدولة الوطنية هي الحل!

عبد المنعم سعيد
بقلم : عبد المنعم سعيد
لمن لا يعلم فإن كاتب السطور جاء من عالم «الأكاديمية» وفيها تخصص في «إدارة الأزمات الدولية»، وكتب كثيراً في ما عُرف بقضية العرب «المركزية» التي دارت فيها أزمات وحروب وصراعات بين العرب والإسرائيليين، خلال أكثر من سبعة عقود. وخلال هذا الزمن، وبعد الحروب خصوصاً، وعندما تأتي المفاوضات بعد وقف إطلاق النار، فإن تعبير «إجراءات بناء الثقة»، خصوصاً بين الفلسطينيين والإسرائيليين، كان شائعاً للغاية. ولكن التعبير، الآن، بات مطلوباً بين العربي والعربي الآخر؛ وأكثر طلباً بين الفلسطيني والفلسطيني الآخر. وكان فرنسيس فوكوياما قد شاع وذاع اسمه عندما كتب عن «نهاية التاريخ»، ولكن الواقع هو أن أهم كتبه على الإطلاق كان بعنوان «الثقة أو Trust» الذي كان هو الرابطة الأساسية في تقدم العالم المعاصر. فالمجتمعات تتكون لأن بين أفرادها رواية مشتركة تسمى الهوية، ولكنها لا تستمر من دون مصالح تجمعها، ومن دون تحديات تواجهها، وربما تهديدات تخاف منها، فيكون ذلك بذرة ما نسميه «القومية» التي هي حجر الزاوية في «الدولة الوطنية» التي توجد فيها سلطة يكون لها الحق الشرعي في استخدام السلاح.
ولكن أعظم ما يجعل المجتمع مجتمعاً بحق، وفقاً لفوكوياما، هو «الثقة» الواقعة بين الأفراد والأُسر والجماعات الفرعية. صحيح أن المجتمعات تحكمها عادات وتقاليد، وقوانين ودساتير، وسلطات لها أسنان من القوة والمحاكم والسجون؛ ولكن كل ذلك لا يقيم مجتمعاً اجتمع أفراده على الشك والتوجس وعدم الثقة في الآخر. ولكن الثقة ليست ضرورية فحسب بين المجتمعات وبعضها، وبين الجماعات داخل المجتمع الواحد، وإنما أيضاً بين الإنسان والبيئة التكنولوجية التي يعيش فيها. ولدى جماعة بيننا حذر شديد من التعامل مع ماكينات البنوك للحصول على الأجر أو المعاش؛ لأن هناك انعداماً للثقة في أن تلك الماكينة العجيبة لن تبتلع بطاقة الائتمان، أو أنها بعد إدخال كلمة السر سوف تلبي بإخراج النقود. في العالم كله أخذت الآلة وقتاً حتى يثق بها الإنسان الذي كان يعرف فقط الثقة أو عدم الثقة في إنسان آخر، سواء أكان منتجاً أم مستهلكاً، أم في هذه الحالة صرافاً، مهما كان في الأمر ازدحام.
اللحظة الراهنة في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، أو بين «حماس» وإسرائيل، تفرض موقفاً بات فيه السلام مطلوباً من طرفين كلاهما يريد استمرار الحرب. إسرائيل نتنياهو ورفاقه من «الإخوان اليهود» يريدون حرباً تغطي على الاستيطان وفرص ضم الضفة الغربية وإخضاع غزة كلية في الطريق، وربما أطراف إقليمية أخرى تشملها «إسرائيل الكبرى» أو في سبيلها إلى إعادة تشكيل الشرق الأوسط. «حماس» أو «الإخوان المسلمون» يخوضون حربهم في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 من دون معرفة بماذا سوف تكون حال الحرب في 8 من أكتوبر إلا من خبرة أربع حروب سابقة كانت فائدتها هي تثبيت «حماس» في دولة صغرى أو «Mini State» تكفي للبعد عن السلطة الوطنية الفلسطينية «الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني». معركة الإطاحة بالسلطة من غزة سبقت القارعة بسنوات؛ وفي ما بينهما كانت إسرائيل تنقل المال وتعطي السماح بصيد السمك في البحر المتوسط مع الغاز والكهرباء. هذه هي الصورة الأصلية للحرب التي في واقعها دارت لحسم صراعات داخلية تنتهي بتوجه إمبراطوري لدى إسرائيل، ودولة صغرى تكون فاتحة للاستقلال الفلسطيني المغلف بأغطية «شرعية». النزال في النهاية أوصلَنا إلى الحالة التي عليها وقف إطلاق النار في غزة، من دون قدرة على الانتقال من النقطة الأولى إلى الثانية في قائمة طويلة وضع فيها الرئيس ترمب عشرين نقطة تدور حولها مفاوضات تبحث عمن يقوم بها.
في غياب الثقة التي شجعَنا عليها «فوكوياما» فإن الدول العربية المشارِكة في عملية السلام الجديدة، والمختلفة نوعياً بحكم المفاجأة والمذبحة التي جرت في الحرب، تواجه الحقائق المُرة للدولة الوطنية العربية في مشروعها الفلسطيني. الحقيقة التي لا يمكن الغياب عنها أن إشكالية قيام الدولة الفلسطينية المستقلة والمعترف بها دولياً لن تقوم ما دامت «حماس» مصممة على تسليم سلاحها بعد قيام الدولة الفلسطينية التي تفقد شرعيتها إذا ما بقيت ميليشيات تحمل سلاحاً؟! المرض شائع في لبنان وسوريا واليمن والسودان، حيث تتمسك كل الميليشيات بالسلاح، ليس لكي تحمي وطناً وإنما لكي تمنعه من القيام. الآن هناك 12 دولة عربية لا يوجد بها هذا النوع من الدفاع، ولا توجد بها حروب أهلية أو شروع فيها، ولديها «رؤية» زمنية للتنمية - 2030 - والاستقرار والرخاء، بعدها تدخل الدولة إلى قائمة التقدم في العالم. واجب هذه الدول «الوطنية» أن تعلن شريعتها في الإقليم العربي حيث الإصلاح والسلام والبناء، لا تفترق ولا تسمح لجماعات مسلحة باحتكار قرارات الحرب والسلام.
GMT 22:43 2025 الأربعاء ,05 تشرين الثاني / نوفمبر
العمدةGMT 22:41 2025 الأربعاء ,05 تشرين الثاني / نوفمبر
سمير زيتوني هو الأساسGMT 22:36 2025 الأربعاء ,05 تشرين الثاني / نوفمبر
عن الجثث والمتاحف وبعض أحوالنا...GMT 22:34 2025 الأربعاء ,05 تشرين الثاني / نوفمبر
السودان... اغتيال إنسانية الإنسانGMT 22:32 2025 الأربعاء ,05 تشرين الثاني / نوفمبر
غزة... القوة الأممية والسيناريوهات الإسرائيليةGMT 22:30 2025 الأربعاء ,05 تشرين الثاني / نوفمبر
النائب الصحفىGMT 22:27 2025 الأربعاء ,05 تشرين الثاني / نوفمبر
بند أول فى الشارقةGMT 20:45 2025 الأربعاء ,05 تشرين الثاني / نوفمبر
خناقات (النخبة)!!الخطوط المغربية تتسلم طائرات جديدة ضمن خطة تحديث أسطولها بداية من 2028
الرباط - المغرب اليوم
قال الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الملكية المغربية عبدالحميد عدو إن الشركة تتوقع البدء في تسلم طائرات من مناقصة كبرى لتوسيع أسطولها اعتباراً من عام 2028. وأضاف أن المناقصة التي طرحت في أبريل 2024 طلبت ما يصل إلى 200 طائر�...المزيدأحمد سعد يكشف عن تجربة جديدة في مسيرته الفنية من خلال خوضه البطولة المطلقة في عالم السينما
القاهرة - المغرب اليوم
أعلن النجم أحمد سعد عن خطوة مفاجئة هي الأولى من نوعها في مسيرته، حيث كشف عن تجربة جديدة في مسيرته الفنية من خلال خوضه البطولة المطلقة في عالم السينما. وكشف سعد في تصريحات لبرنامج "بيلبورد بالعربي"، عن تحضيره لف...المزيدمن ألواح نينوى إلى شرائح السيليكون رحلة الطب من الطين إلى الذكاء
الرياض - المغرب اليوم
في زمنٍ تُعيد فيه الخوارزميات رسم خريطة الجسد البشري بدقةٍ تفوق عدسة الجرّاح، يبرز سؤالٌ يتجاوز ضجيج التقنية إلى صمت الحكمة القديمة: من نحن حين تُصبح أجسادنا بيانات؟ وهل ما نراه من تَقدّمٍ مذهل يقودنا فقط نحو مستقب...المزيد Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©